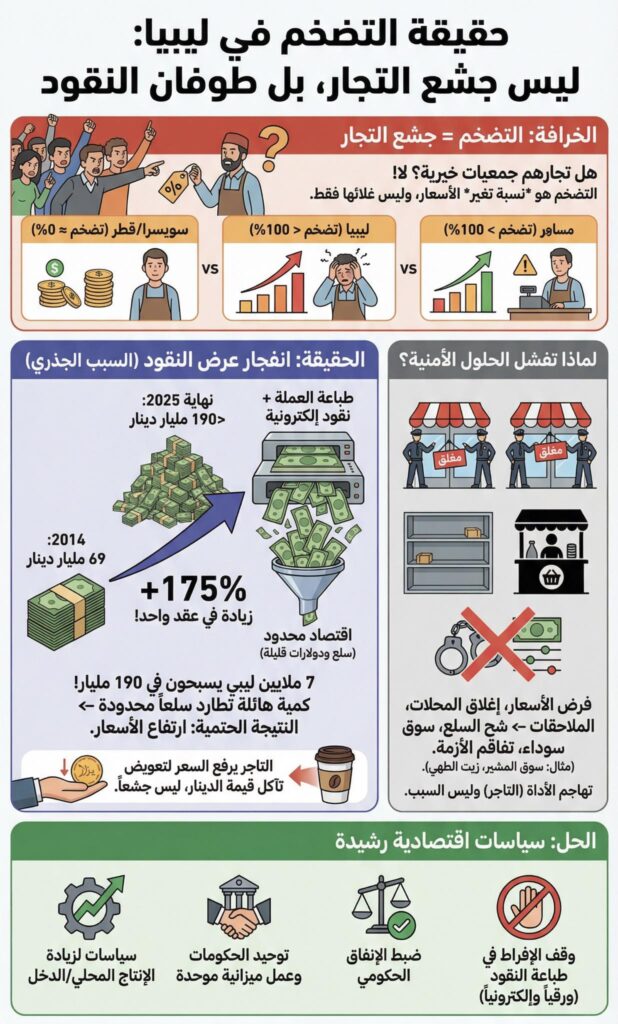“منذر الشحومي”: تعدد أسعار الصرف في ليبيا وحلقة المضاربة “الأربيتراج”
كتب: منذر الشحومي / الخبير المصرفي والمالي
أولًا: بنية حلقة المضاربة (الأربيتراج)
تعدد أسعار الصرف: التشوّه الأساسي
تعمل ليبيا في ظل:
• سعر صرف رسمي
• سعر صرف في السوق الموازية
• وأحيانًا أسعار فعلية مختلفة عبر الرسوم أو القيود المستندية
عندما يكون السعر الرسمي أقل من السعر الذي يحدده السوق، ينشأ فورًا هامش مضاربة:
شراء الدولار بالسعر الرسمي → بيعه في السوق الموازية → اقتناص الفارق.
وإذا كان الفارق كبيرًا (كما حدث تاريخيًا)، يبدأ الاقتصاد بإعادة تنظيم نفسه حول الوصول إلى العملة الأجنبية بدلًا من الإنتاج.
يتحول فرق السعر إلى:
• مصدر ريع
• أداة تفاوض سياسي
• آلية إعادة توزيع غير رسمية
وهنا تبدأ الحلقة.
التخصيص التقديري للعملة الأجنبية: من يحصل على الدولار الرخيص؟
نظرًا لمحدودية النقد الأجنبي، يصبح الوصول إليه إداريًا.
يتم تخصيص العملة عبر:
• الاعتمادات المستندية
• التحصيلات المستندية
• الموافقات الخاصة
• أولويات قطاعية
بمعنى:
• ليس الجميع قادرًا على الحصول على الدولار الرسمي.
• التخصيص قائم على القرار، لا على السعر.
وهنا يصبح الفارق قابلًا للتحويل إلى أرباح.
وتظهر سلوكان رئيسيان:
1. المبالغة في فواتير الاستيراد
استيراد فعلي بقيمة مليون دولار → التصريح بثلاثة ملايين → بيع الفارق في السوق الموازية.
2. استيراد وهمي
فتح اعتماد → لا بضائع حقيقية → بيع الدولار في السوق الموازية.
يتحوّل شباك النقد الأجنبي إلى مركز أرباح.
وهذا يزيد:
• الطلب المصطنع على الدولار
• الضغط على الاحتياطيات
• الاختلالات النقدية
تقنين السحب النقدي: مضاعِف التشوّه
عندما تُفرض قيود على السحب النقدي:
• لا يستطيع المواطن سحب أمواله بحرية.
• تظهر علاوة على النقد الورقي.
• تصبح الودائع أقل قيمة من النقد.
تنشأ هنا مضاربة جديدة:
وديعة → تحويل إلى دولار → بيع → العودة إلى نقد بعلاوة.
شح السيولة يضاعف أثر فجوة سعر الصرف.
كما يضعف الثقة بالنظام المصرفي، ويدفع النشاط إلى السوق غير الرسمية.
دعم الطاقة: التسرب الهيكلي
تدعم ليبيا الوقود بشكل واسع.
عندما تكون الأسعار المحلية:
• أقل بكثير من الأسعار الدولية
• ومدفوعة بدينار ضعيف
يصبح التهريب منطقيًا اقتصاديًا.
لكن الأهم:
الدعم يتطلب عملة صعبة لاستيراد المنتجات المكررة.
إذًا: دعم الطاقة → زيادة طلب على الدولار → ضغط على الاحتياطيات → تشديد التخصيص → اتساع الفجوة → تعاظم المضاربة.
الحلقة تكتمل.
ثانيًا: الحلقة المغلقة — كيف تصبح ذاتية التغذية؟
1. تظهر فجوة سعر الصرف.
2. تنشأ فرص المضاربة.
3. التخصيص الإداري يتيح اقتناص الفارق.
4. يرتفع الطلب المصطنع على الدولار.
5. تنخفض الاحتياطيات.
6. تضعف الثقة.
7. يرتفع سعر السوق الموازية.
8. تتسع الفجوة.
9. يشتد تقنين السيولة.
10. تضعف البنوك.
11. يتوسع التهريب.
12. يرتفع العبء المالي.
13. يزداد الضغط على النقد الأجنبي.
14. تبدأ الدورة من جديد.
هذه ليست عملية خطية.
إنها تكرارية.
كل تشوّه يعزز الآخر.
الدينار لا يضعف بسبب صدمة واحدة — بل لأن النظام نفسه يُنتج طلبًا مستمرًا على الدولار.
ثالثًا: لماذا لا يكفي “التخفيض” وحده؟
كثيرون يقولون:
فلنُخفض العملة ونوحد السعر.
لكن إذا تم التوحيد دون:
• إصلاح الدعم
• إلغاء التخصيص التقديري
• معالجة أزمة السيولة
فإن الفجوة ستعود.